شكّلت أوروبا عنصراً محورياً في معظم المنافسات التي اشتعلت بين قوى كبرى على مدار الـ500 عام الأخيرة، سواء أكانت موطناً لأحد طرفي الصراع أو لكليهما أم مسرحاً حاسماً لجهود المقاومة، والدليل على ذلك الحربان العالميتان اللتان اشتعلتا في القرن الماضي. لكن الحال لم تعد كذلك اليوم. ومع ذلك، ما زالت الدول الأوروبية قادرة على الاضطلاع بدور محوري في الصراع الأكبر في القرن الحالي، بين الصين وأميركا، وإلا ستتراجع مكانة القارة الأوروبية، لتصبح مجرد منطقة ضعيفة ومنقسمة على نفسها، تناضل من أجل ممارسة بعض النفوذ.
من جانبها، تأمل الصين في تحقيق السيناريو الأخير، ولديها بالفعل استراتيجية لإنجاز ذلك. أما الولايات المتحدة، فينبغي أن يكون رهانها على مجموعة قوية ونشطة من الحلفاء الأوروبيين. ومع هذا، غالباً ما خدمت سياستها أهداف بكين.
الملاحظ أن مركز الجاذبية الجيوسياسية في العالم يتحرك بثبات نحو الشرق منذ عقود. واليوم، تفوق منطقة آسيا والمحيط الهادي بفارق كبير حصة أوروبا في إجمالي الناتج العالمي والإنفاق العسكري. ورغم خطورة التنافس القائم بين روسيا والغرب، يبقى الصراع عبر المحيط الهادي بين الصين وأميركا على درجة كبرى من الأهمية التاريخية.
ومن الممكن أن تشكل أوروبا ثقلاً فارقاً في هذه المنافسة، إذا ما تدخلت للدفاع عن النظام الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي استفادت منه القارة بدرجة هائلة. اليوم، ما زال الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وهذا أصل ليس بالهين في خضم تنافس جيو – اقتصادي محموم. وما زال عدد قليل من الحلفاء الأوروبيين، خاصة فرنسا والمملكة المتحدة، قادراً على نشر قواتهم العسكرية عالمياً، بينما يبقى بمقدور أوروبا الثرية نسبياً تحسين قدراتها العسكرية بدرجة هائلة إذا ما اختارت ذلك. أيضاً، بمقدور الدول الأوروبية ممارسة نفوذ دبلوماسي كبير، خاصة عبر الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وربما يكون الأمر الأهم أن أوروبا ما زالت المجموعة الأكثر تناغماً من الديمقراطيات بالعالم، الأمر الذي يحمل أهمية كبيرة لدى اندلاع تنافس بين قوة ليبرالية وأخرى غير ليبرالية.
وكانت هناك بعض التحركات نحو نشاط أوروبي أكبر في مواجهة الصين. كانت المملكة المتحدة وفرنسا قد حرّكتا بوارج حربية في بحر الصين الجنوبي رداً على عدوان صيني. كما أبدت القيادة الألمانية قلقاً أكبر حيال انتهاكات الصين لحقوق الإنسان ومساعي بكين للهيمنة على صناعات التكنولوجية المتقدمة.
أما المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فقد شرعت في دراسة فكرة أن الصين تمثل «منافساً اقتصادياً يسعى وراء القيادة التكنولوجية، ومنافساً ممنهجاً يروج لأنماط بديلة للحكم». وتكتسب مقترحات تعزيز جهود مراقبة الاستثمار الصيني وتعزيز مجالات الاتصالات عن بعد والصناعة والابتكار الأوروبية في مواجهة النفوذ والقرصنة الصينية، تأييداً متزايداً.
وبالمثل، حذّر جينز ستولتنبرغ، الأمين العام للناتو، من أن «الصين تقترب منا»، ودعا إلى تعزيز التعاون الأوروبي مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وعند التطلع للمستقبل، يمكن للمرء تخيل تعاون أوروبا والولايات المتحدة والأنظمة الديمقراطية في منطقة آسيا والمحيط الهادي على التصدي للنفوذ السياسي الصيني، وربما التنسيق فيما بينها بصراحة أكبر حول إدارة التهديدات العسكرية في كثير من المناطق في آنٍ واحد. إلا أن تأثير الإجراءات الأوروبية تجاه الصين سيعتمد على مدى وحدة صفّ دول القارة، وعلى هذا الصعيد تحديداً، ثمة مؤشرات تدعو إلى القلق.
في الوقت الذي أصبحت بعض القوى الكبرى في أوروبا، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، أكثر تشككاً تجاه السياسات الصينية، فإن كثيراً من الدول الأعضاء الأصغر والأكثر فقراً، خاصة بالجنوب والجنوب الشرقي، بدأت تنظر إلى بكين باعتبارها مصدراً للتجارة ورؤوس الأموال التي تحتاجها هذه الدول بشدة. على سبيل المثال، عام 2017 كان اليونانيون أكثر احتمالاً لأن يشيروا للصين (53 في المائة) عن الولايات المتحدة (36 في المائة) باعتبارها ثاني أهم شريك تجاري للبلاد بعد الاتحاد الأوروبي. كما أن صعود التوجهات السياسية غير الليبرالية في دول مثل المجر وبولندا خلق تصدعاً في الوحدة الديمقراطية للقارة. ويقف الاتحاد الأوروبي على أعتاب خسارة واحد من أهم أعضائه، مع تحرك بريطانيا نحو بريكست. وربما ستكون أوروبا عنصراً استراتيجياً فاعلاً، لكنها ربما تفتقر إلى التناغم.
ويعتبر هذا خبراً ساراً للصين، لأن أوروبا متناغمة وثرية وديمقراطية لن تقف إلى صفّ الصين في مواجهة الولايات المتحدة، بالنظر إلى الصدام الجوهري بين القيم الليبرالية ونظام بكين. كما أن أوروبا التي ازدهرت في نظام عالمي تقوده الولايات المتحدة لن تشعر بالارتياح حال قيام نظام دولي تجاري تقوده الصين، والذي يتطلب خضوعاً صارماً من جانب القوى الأصغر. لذلك، فإن ما تأمل فيه الصين وجود أوروبا مقسمة وعاجزة عن الوقوف بحسم إلى جانب واشنطن بسبب انقساماتها الداخلية وانحسار التزامها بالليبرالية واعتمادها على استثمارات بكين. ليس بمقدور الصين الفوز بمساندة أوروبا، لكن بإمكانها تحييدها من خلال تمزيق القارة واجتذاب أجزاء منها.
وهذا بالفعل ما تفعله الصين التي تعمد إلى تعزيز روابطها مع دول أوروبا الأصغر والأكثر فقراً والأقل ليبرالية في الغالب، من أجل تقويض وحدة الاتحاد الأوروبي وتعزيز نفوذها داخل الدول الأعضاء الفردية. وقد حقّقت بكين نصراً هائلاً هذا الربيع بنجاحها في إقناع إيطاليا بالانضمام إلى مبادرة «الحزام والطريق». وبالتأكيد يسير النفوذ السياسي والدبلوماسي في الطريق التي يسير بها النفوذ الاقتصادي.
في المقابل، فإنه قد يظن البعض أن الولايات المتحدة ستستجيب لهذا الوضع، عبر تعزيز أوروبا موحدة وديمقراطية، لكن للأسف هذا لم يحدث. لقد اتبعت إدارة ترمب كعادتها سياسة غير متناغمة إزاء أوروبا، عبر مطالبتها بإبداء الصرامة تجاه الصين، بينما تبدي أميركا الصرامة تجاه القارة.
وقد ساند الرئيس ومستشاروه بريكست، الذي سيلحق الضعف بالاتحاد الأوروبي، ويقضي على صوت موالٍ لأميركا بداخله.
في الوقت ذاته، حاولت إدارة ترمب تعبئة الاتحاد الأوروبي ضد الصين، وضغطت على الدول الأعضاء بالاتحاد كي لا تدخل في شراكات مع شركات صينية بمجال شبكات الجيل الخامس، إلا أن كثيراً من الدول الأوروبية تشعر بالقلق من الوقوف إلى جانب واشنطن في مواجهة بكين على نحو مفرط، خوفاً من أن تبرم واشنطن اتفاقية ثنائية نهاية الأمر مع بكين.
من جانبه، يرى ترمب أن الولايات المتحدة سيكون بمقدورها إبرام معاهدات ثنائية أفضل مع بريطانيا بعد بريكست، وربما يعتقد أن بلاده بمقدورها تعزيز نفوذها لدى الدول الأوروبية الفردية حال إضعاف الاتحاد الأوروبي. وربما تعينه هذه الاستراتيجية بالفعل في بعض المفاوضات مع حلفاء أوروبيين، لكنها لن تعين الولايات المتحدة في مواجهتها الخطرة أمام الصين. إعداد “الشرق الأوسط”


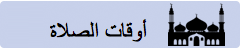
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.