كتبت/ أسماء ربيع المنهالي
ليس كلُّ صوتٍ يُسمَع، ولا كلُّ مسافةٍ تُقاس بالخطوات.
بعضُ الأصوات تعبر المسافات؛ لأنها تنبع من صدقٍ عميق، فتصل مباشرةً إلى القلوب.
اليوم، لا نحتفل بذكرى ميلادٍ فحسب، بل نتأمّل مسيرةَ إنسان؛ تشكّلت من ينبوع الحكمة، واتّسعت بفيض الإنسانية، وسيظل أثرها — بإذن الله — ممتدًا عبر الزمن والعصور.
لا يمكن تجاوز المسار الإنساني العالمي الذي مثّله فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عبر عقودٍ من العمل الفكري والأخلاقي. ، فقد ارتبط اسمه بمبادراتٍ حوارية كبرى، وبجوائز وتكريماتٍ محلية وإقليمية ودولية، جاءت اعترافًا بدوره في تعزيز السلام، والدفاع عن كرامة الإنسان، وترسيخ قيم الأخوّة الإنسانية بوصفها ممارسةً لا شعارًا.
وهي إنجازات لا أذكرها من باب التعداد، بل للإشارة إلى أن هذا الصوت الرصين، الأصيل، القادم من أرض الكنانة، لم يكن يومًا معزولًا عن العالم، بل حاضرًا في ضميره، ومؤثّرًا في مساراته.
وما يلفتني في هذه المسيرة ليس اتساعها الدولي فحسب، بل قدرتها النادرة على الحفاظ على جوهرها الإنساني، حتى في أكثر لحظاتها علنية.
خلال حضوري قمة الإعلام العربي 2025، استمعت إلى كلمة الإمام الأكبر؛ ذلك الرمز الديني الراسخ في عمق الفكر والإنسانية. كان شاهدًا حيًا على مرحلةٍ مفصلية في تاريخ التلاقي الإنساني، وأحد موقّعي وثيقة الأخوّة الإنسانية في مدينة التسامح، أبوظبي، عام 2019.
حضوره فريد؛ يظهر في نبرته، ويترك أثره الهادئ في النفوس.
بسيطٌ هو، لكن بساطته تنبع من صدقٍ لا يدع مجالًا للتكلف، كما قال ذات مرة:
“سامحوني، أنا صعيدي وصريح”.
كتبتُ عنه مقالًا تحت عنوان:
“أحمد الطيب.. حكمة وصوت الأخوّة الإنسانية”
ثم جاءني صوته عبر الهاتف.
كلامه لا يمرّ مرور الكرام، بل يستقر في أعماق الروح.
لا يُلقي دروسًا، بل يُحيي الهمم.
ولا يفرض قناعات، بل يضع أمامك مرآةً ناصعة — لا تُدينك، بل تسألك.
يمضي عالمُ اليوم بسرعة البرق؛ تسبق فيه الثواني اللحظات، وتختبئ المعاني العميقة في دقائق معدودة.
وفي خضمّ هذا التسارع، قد تُضيء الكلمات — في أربع دقائق فقط — طريقًا بأسره.
تفاصيل تلك اللحظة، ومشاعر ذلك اليوم، وما كان يدور في حياتي الشخصية والإنسانية، ربما لن أشاركها مع أحدٍ سواه. وقد كان لي الشرف أن أشاركها معه، ومع سعادة المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين.
وفي خضمّ هذا الامتنان العميق، يستحيل عليّ ألّا أتوقف لأقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
فشكرًا لدعمٍ جاء كجبر، ولتكليفٍ لم أثقله على القلب، بل وسّعه، وجعل للكلمة سندًا، وللنية طريقًا أوضح.
هذا ما حدث لي خلال مكالمةٍ هاتفية تفوق الوصف ويقف عندها التعبير؛ مكالمة مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أطال الله في عمره.
في تلك اللحظة، لم يكن الهاتف مجرّد وسيلة اتصال، بل مساحة أمان، وطمأنينة، وسكينة.
لم تكن مجرّد محادثة، بل لحظةً من لحظات العمر، امتزج فيها التكليف بالتشريف، والكلمة بالدعاء؛ فكانت أقرب إلى طقسِ تنصيبٍ داخلي، ووسامٍ لا يُرى.
قال لي الإمام: “يا ابنتي، لن أنساكِ من الدعاء إن شاء الله، وبإذن الله سأستمر في السؤال عنكِ”.
أحدثت تلك العبارة في داخلي يقينًا جديدًا، وسكينةً لا تُوصَف بالكلمات. لم تكن دعمًا عابرًا، بل امتدادًا طبيعيًا لمنهجٍ يضع الإنسان في المقدّمة؛ حيث يأتي الدعاء قبل الخطاب، ويصبح السؤال عن الآخر جزءًا من الإيمان.
وحين يتحوّل الدعاء من فعلٍ شخصي إلى موقفٍ أخلاقي، يُصبح شكلًا من أشكال القيادة الصامتة.
في تلك اللحظات، تتراجع الكلمات، وتغدو السكينة هي اللغة المكتملة.
من تلك اللحظة وُلد هذا النص.
لا بدافع العمل، بل من موقع العاطفة.
كانت تلك المكالمة نقطة تحوّل – ليس في مسيرتي الكتابية فحسب، بل في مسار حياتي. نيشانٌ لا يُعلَّق على الصدر، بل زُرع في العمق.
وفي منشورٍ على حساب الأزهر الرسمي في “إنستغرام”، كُتب بهذه المناسبة:
استحضرتُ كلماته التي لخّص بها عمرًا كاملًا:
“حياتي كلّها لطفٌ من الله… كلماتٌ قليلة تختزل ثمانين عامًا”.
اعترافٌ لا يحمل فخرًا، بل امتنانًا.
فالحياة — كما يراها — ليست إنجازًا يُستعرض، بل منّة من الله، ومسؤولية شكر، وواجبًا أخلاقيًا.
وفي زمنٍ تكثر فيه الأصوات، أدركتُ أكثر من أي وقتٍ مضى أن الصوت الحقيقي ليس الأعلى، بل الأصدق.
وأن الباطل – كما قال الإمام – لا يعلم إلا في غفلة الحق، فهو لا يستمدّ قوته من ذاته، بل من تراجع أصحاب الحق عن مسؤوليتهم.
وفي عالمٍ تتصدّر فيه المشهد أصواتٌ عالية بلا بوصلة ولا فكر، نزداد يقينًا بأن العالم اليوم — أكثر من أي وقتٍ مضى — بحاجةٍ إلى قادةٍ من هذا الطراز:
قادة لا يختصرون القيادة في القوة، ولا الحكمة في الخطاب، بل يجسّدونها في الاتساق بين القول والفعل، وفي إنسانيةٍ ترى الإنسان أولًا… دائمًا.
صوتٌ اختار أن يكون جسرًا…
فصار فكرًا، وموقفًا، وعملًا.
وحين أثنى الإمام على فكري وقلمي، أدركتُ أن ما زُرع في البيت الأول لا يضيع، وأن الكلمة حين تُربّى بصدق، تجد طريقها — ولو بعد حين.
وهنا كتبتُ مقالي:
“أنا ابنةُ رجلٍ لم يدخل المدرسة… لكنه أنشأني على نور الكلمة”.
في حضرته، نعيد اكتشاف المعنى الحقيقي للقيادة الأخلاقية:
الصدق دون استعراض، والشجاعة دون صخب، والعلم حين يلتقي التواضع.
وهو تواضعٌ لا يُمثّل ضعفًا، بل وعيًا عميقًا بالغاية، كما في الحديث الشريف:
“وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله”.
وقد جسّد الإمام هذا الرفع — لا رتبةً فحسب، بل رفعةً في الأثر، وتطابقًا نادرًا بين القول والفعل.
ثمانون عامًا من الحكمة والرحمة ليست مناسبةً للاحتفال فقط، بل دعوةً إلى التأمّل:
كيف يكون الإنسان راسخًا دون أن يتحجّر؟ واضحًا دون أن يقسو؟ عميقًا دون أن يقع في فخّ التعقيد؟
وفي عصرٍ تتعالى فيه الأصوات، تبقى بعضُ الأعمار صوتًا واحدًا يكفي… لأن بعض الأصوات لا تبحث عن العلو، بل تعرف الطريق.
أما تلك المكالمة، فستبقى لحظةً خارج الزمن.
احتفظتُ بتفاصيلها في مكانٍ آمن داخلي، لا كتمانًا، بل لأنها جاءت بلسمًا وجبرًا
في وقتٍ كانت فيه أمورٌ كثيرة تُرمَّم بصمت.
فبعض اللحظات لا تُكتب لتُروى، بل لتكون غذاءً للروح.



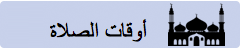
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.