التكييف القيمي: جدال تشديد الهجرة بين اعتبارات الأمن والحقوق في أوروبا
وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم ببروكسل، يوم 8 ديسمبر 2025، على إجراءات أكثر تشدداً لتقييد الهجرة غير النظامية واللجوء؛ بما يشمل فتح “مراكز عودة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا ينتمون إليها، ولكن تعتبرها أوروبا آمنة فيما يُعرف بـ”الدول الثالثة الآمنة”. وفي 17 ديسمبر الجاري، أقر البرلمان الأوروبي نصين يشددان سياسة الهجرة، يتضمن الأول تدابير تشمل ترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة، والثاني إعداد قائمة بـ”الدول الآمنة”.
وبينما تعكس هذه التحولات رغبة صارمة في الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية؛ فإنها تطرح تساؤلاً جوهرياً مفاده: هل تُشكل هذه التحولات قطيعة صريحة مع قيم أوروبا المعلنة والمتمثلة في كرامة الإنسان وسيادة القانون والتضامن، أم أنها إعادة تفسير مُتنازع عليها أو إعادة تكييف لهذه القيم تحت ضغط الظروف الحالية؟
مسار متشدد:
يُلاحظ المتابع للسياسات الأوروبية تجاه الهجرة في السنوات الأخيرة، توجهاً متزايداً نحو تقييد الهجرة غير النظامية، وتشديد إجراءات اللجوء؛ بهدف خفض أعداد الأفراد القادمين إلى أوروبا من الخارج؛ إذ تحولت هذه السياسات من مجرد استجابة مؤقتة للأزمة إلى تحولات جذرية شاملة في الفكر الأوروبي لقضية الهجرة، في ظل تدفقات غير نظامية تجاوزت مليون شخص سنوياً في سنوات الذروة منذ عام 2015.
ففي سبتمبر 2020، تبنت المفوضية الأوروبية نهجاً يرتكز على الضبط المسبق للحدود؛ إذ قدمت دعماً لليونان باعتبارها “خط الدفاع الأول للاتحاد الأوروبي” في مواجهة تدفقات الوافدين عبر بحر إيجه، كما أنشأت مراكز استقبال جديدة بهدف تسريع إجراءات البت في الطلبات. وفي أعقاب توظيف بيلاروسيا لقضية المهاجرين عبر الحدود البولندية، شملت الردود الأوروبية تحركات دبلوماسية متبادلة، وتنسيق سياسات التأشيرات في منطقة غرب البلقان. وفي السياق نفسه، وسّعت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” (Frontex) نطاق مهامها في عمليات الإعادة وإعادة الإدماج إبان التحديات التي فرضتها جائحة “كورونا”.
ومع ذلك، أدت الحرب الروسية في أوكرانيا منذ فبراير 2022 إلى تفعيل توجيه الحماية المؤقتة الصادر عام 2001؛ مما أتاح استقبال أكثر من 4 ملايين شخص، دون إخضاعهم لإجراءات اللجوء المعتادة. بينما تراجعت ألمانيا عن النهج المنفتح للمستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، عقب المكاسب التي حققها اليمين المتطرف في عام 2023؛ لتتجه إلى تقليص المزايا، وشن حملات لإعادة المهاجرين، وإعادة فرض عمليات التفتيش على الحدود.
ومع مد هذا الخط المتشدد على استقامته، اعتمد الاتحاد الأوروبي، في مايو 2024، بعد مفاوضات استمرت لسنوات، الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء؛ ليحل محل اتفاقية دبلن الثالثة، مع لائحة جديدة لإدارة الهجرة واللجوء، تهدف إلى تحسين إدارة الهجرة، وتعزيز الرقابة، وتسريع إعادة طالبي اللجوء المرفوضين؛ حيث تشمل إجراءات من بينها عمليات تفتيش إلزامية على الحدود، واستحداث آلية تضامن لإعادة توطين نحو 30 ألف شخص سنوياً، مع منح الدول الأعضاء خياراً بين استقبال طالبي اللجوء أو المساهمة المالية بمبلغ 20 ألف يورو عن كل شخص ترفض استقباله؛ بما يؤدي إلى إنشاء صندوق تضامني تُقدر قيمته بنحو 420 مليون يورو. ومن المقرر البدء في تنفيذ هذا الميثاق في يونيو 2026.
ولم يكتف المسؤولون الأوروبيون بهذه الإجراءات، بل واصلوا اتخاذ مجموعة أوسع من التدابير المشددة؛ والتي شملت الإجراءات التي وافق عليها وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في 8 ديسمبر الجاري، ثم تدابير أقرها البرلمان الأوروبي في 17 ديسمبر الجاري.
دوافع أوروبا:
اللافت في هذا الخط الأوروبي المتشدد تجاه الهجرة أنه، وإن كان مدفوعاً منذ البداية من تيارات اليمين المتطرف، أصبح أداة توظفها الأحزاب التقليدية والمحافظة في أوروبا للحفاظ على مكانتها السياسية. وبينما يدّعي الساسة الأوروبيون أن هذه الإجراءات المشددة تهدف إلى حماية القارة، يظل جوهر هذه التدابير مخالفاً للقيم الأساسية الأوروبية المُعلنة سواء حقوق الإنسان أم التضامن العالمي أم حماية التنوع الثقافي. ويستدعي ذلك تفكيك بنية هذه التوجهات الجديدة وفهماً أدق لدوافعها الحقيقية، والتي تتمثل فيما يلي:
1- استعادة ثقة الناخبين الأوروبيين في الأحزاب التقليدية: خلال السنوات الماضية، أدى الضغط المتزايد من الأحزاب القومية واليمين المتطرف، الذي اكتسب شعبيته الحالية من تركيزه على برامج وخطابات معادية للمهاجرين، إلى دفع أحزاب الوسط ويمين الوسط الأوروبية إلى تبني سياسات أكثر تشدداً تجاه الهجرة استجابة للمخاوف من فقدانها لمكانتها السياسية لصالح التيارات القومية واليمينية.
ومع الأخذ في الاعتبار انخفاض حالات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 22% خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025 لتصل إلى 152 ألف حالة، فإن الإجراءات المشددة الحديثة، والتي لن تكون الأخيرة في هذا المسار، مدفوعة بأسباب سياسية؛ لكونها لا تعكس رؤية أصيلة لأوروبا تجاه مسألة الهجرة بقدر ما تشير إلى سعي التيارات التقليدية بالأساس إلى عدم فقدان السلطة والسيطرة. فتاريخياً، لطالما اتسمت أوروبا بالانتقائية في تقديم قيمها؛ التي تُعد بمثابة مجموعة مرنة من الإجراءات، تُطبق بشكل مختلف تبعاً للأصل والعرق والتوقيت والسياق الجغرافي والسياسي. والدليل على ذلك، تفعيل الاتحاد الأوروبي سريعاً توجيه الحماية المؤقتة للأوكرانيين عقب الحرب الروسية؛ لكنه لم يُقدم إجراءات مماثلة للسوريين في عام 2015 ولا للفلسطينيين الفارين من حرب غزة.
2- تفاقم مخاوف الجريمة: في بعض الدول الأوروبية، ثمة ارتباط متصور بين الهجرة، خاصةً المهاجرين المسلمين، وزيادة معدلات الجريمة؛ مما أدى إلى تأجيج القلق العام ودعم فرض ضوابط أكثر صرامة. وقد أسهمت بعض الحوادث البارزة في السنوات الأخيرة والمعلومات المضللة، التي حركَّتها التيارات المتطرفة على شبكة الإنترنت؛ في تفاقم هذه المخاوف؛ ما أعطى دافعاً للتيارات التقليدية لاتخاذ إجراءات مشددة بداعي الحفاظ على الأمن؛ وهو ما يُكسبها شعبية انتخابية أكبر.
3- تحميل المهاجرين مسؤولية الفشل في تقديم الخدمات العامة: أدى الركود الاقتصادي، ونقص المساكن، والضغط على الخدمات العامة كالصحة والتعليم في عدة دول أوروبية؛ إلى تعزيز نظرة العديد من المواطنين للمهاجرين كعبء على نظام الرعاية الاجتماعية وأنهم منافسين على الوظائف. وبدلاً من أن تسعى الحكومات الأوروبية، التي تقود أغلبها الأحزاب التقليدية الوسطية، إلى معالجة الأسباب الحقيقية لهذه المشكلات الطبيعية الناتجة عن الفشل الحكومي والتطورات الجيوسياسية العالمية؛ فإنها اختارت الطريق الأسهل بتبني وجهة نظر بعض المواطنين وإلقاء اللوم على المهاجرين؛ ما انعكس في سياسات أكثر تشدداً تجاههم.
4- تقسيم أعباء الهجرة بين الدول الأوروبية: على سبيل المثال، وفقاً للإجراءات الجديدة للهجرة؛ ميَّزت المفوضية الأوروبية بين 3 فئات من دولها؛ وهي دول تحت ضغط هجري (إسبانيا، وإيطاليا، واليونان، وقبرص)، ودول تواجه “وضعاً هجرياً ملفتاً” (مثل بلغاريا، والتشيك، وكرواتيا، والنمسا) والتي يمكنها طلب إعفاء كامل أو جزئي من المساهمات المالية، ودول “مهددة بضغط هجري” (مثل فرنسا، وألمانيا، وبولندا، وهولندا) والتي ستُعاد مراجعة وضعها بسرعة؛ إذا تغير مستوى الضغط، وهي إشارة غامضة في معناها العملي. ويهدف هذا التصنيف إلى تقسيم أعباء الهجرة بين الدول الأوروبية أو تقديم مساهمات مالية أكبر في صندوق التضامن. وبصيغة أخرى، يحاول الاتحاد الأوروبي توحيد التوجه نحو الهجرة وإجبار الدول الأعضاء على التحمل المشترك لتكاليف مواجهة هذه الأزمة، في ظل النزاعات داخل الاتحاد على مبدأ تقاسم الأعباء ورفض دول مثل المجر المساهمة مالياً أو حتى استقبال أي مهاجرين.
واللافت في هذه الدوافع أنها تغفل عدة حقائق مرتبطة بالهجرة؛ من بينها تسارع شيخوخة السكان في أوروبا وتقلص القوى العاملة؛ ما يفرض الحاجة إلى عمال جدد في قطاعات مثل الرعاية والبناء، التي تعتمد بشكل كبير على المهاجرين الشباب ذوي الأجور المنخفضة، أو للمساعدة على توليد الحيوية الاقتصادية التي تفتقر إليها أوروبا بشدة. أيضاً بالرغم من أهمية الحفاظ على الأمن؛ فإن شيطنة جميع المهاجرين لها تبعات سلبية خطرة، من أهمها تهميش السكان الأصليين من أصول مهاجرة في القارة الأوروبية، وتقويض الاندماج؛ وهو ما يُفضي إلى تداعيات سلبية أوسع. وأخيراً؛ فإن هذا المسار المتشدد يمثل معضلة تضرب النموذج الثقافي والقيمي الأوروبي في جوهره على المدى البعيد، وإن حقق مكاسب في السيطرة على التدفقات في المدى المنظور.
جدلية القيم:
يستقطب التشدد الأوروبي في مواجهة الهجرة واللجوء اتجاهين متعارضين تماماً؛ يرى الاتجاه المؤيد أن هذه الإجراءات المشددة تُعد استمرارية بل وحفاظاً على القيم الأوروبية المتمثلة في سيادة القانون والأمن والنظام، فضلاً عن سعيها إلى حماية اللاجئين الحقيقيين؛ لكونها تميز بين التنقل غير النظامي وطلبات اللجوء المشروعة.
أما الاتجاه المعارض فتتبناه الجماعات الحقوقية العالمية وكثير من النُقاد، والذين يرون أن هذه الإجراءات الأوروبية بمثابة قطيعة واضحة وانتكاسة خطرة للقيم الأوروبية المتمثلة في كرامة الإنسان، وعدم الإعادة القسرية، وحقوق اللجوء؛ وذلك لكونها تعطي الأولوية للردع على حساب الحماية، وتنذر بانتهاكات منهجية خطرة في ظل الضغوط السياسية في بعض الدول؛ ومن ثم فإن هذه الإجراءات تقوض التزامات أوروبا في مجال حقوق الإنسان.
ووسط تناقض هذين الاتجاهين؛ فإن القضية تحتاج إلى فهم أدق وأعمق. ففي عام 2000، تبنى الاتحاد الأوروبي شعار “متحدون في التنوع” ليعكس التزاماً بالتعددية الثقافية، لكن كانت الانتماءات العرقية والدينية والجغرافية والسياسية محدداً رئيسياً للفرص المتاحة أمام المهاجرين داخل المجتمعات الأوروبية المضيفة. وبالتالي، من هذا المنظور كشفت إجراءات الهجرة واللجوء المشددة عن إطار قيمي متناقض وغير متجانس وموجود بالفعل في الممارسات الأوروبية.
وهكذا يمكن القول إن أوروبا نجحت سياسياً في الترويج لقيمها الأساسية لتكون علامتها المميزة عالمياً، ومع ذلك، كانت قضية الهجرة واللجوء اختباراً حقيقياً لهذه القيم. وأصبح المهاجرون وطالبو اللجوء كبش فداء مناسباً للأوروبيين المحبطين الذين شهدوا تغير مجتمعاتهم وانهيار اقتصاداتهم نتيجة صدمات خارجية متتالية، بدءاً من تغير المناخ وأزمة الصحة العالمية، وصولاً إلى التغير التكنولوجي السريع واضطراب النظام الأمني الأوروبي القائم منذ عقود. وفي ظل هذه الظروف المليئة بالغموض، تراجعت المقاربة الحقوقية للهجرة واللجوء، وباتت تُعد نقطة ضعف سياسية؛ ليحل محلها نهج أكثر تركيزاً على الاعتبارات الأمنية ومنطق الضبط والردع.
خلاصة القول إن التوجه الأوروبي المتشدد إزاء الهجرة واللجوء لا يعكس تراجعاً جوهرياً في القيم الأوروبية، بقدر ما هو إعادة تكييف لها، في ظل منظومة قيمية قابلة للتغيير تبعاً للظروف والسياقات السياسية. وعلى الرغم من أن الحكومات الأوروبية تتوقع السيطرة على تدفقات الهجرة عبر هذه الإجراءات؛ فإنها في المقابل تُراكم مشكلات وتحديات سياسية واقتصادية مستقبلية؛ فما يُسمى بـ”حصن أوروبا” ينطوي على مخاطر قد تؤدي إلى تقويض النمو الاقتصادي، وإرهاق المالية العامة، وإضعاف نموذج دولة الرفاه. وسيكتشف حينها القادة الأوروبيون أن تشديد إجراءات الهجرة لا يوقف التدفقات غير النظامية.



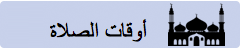
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.